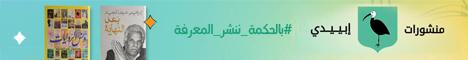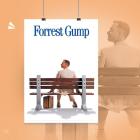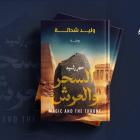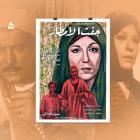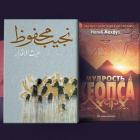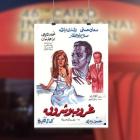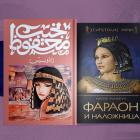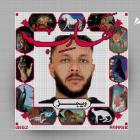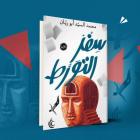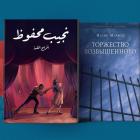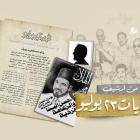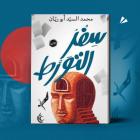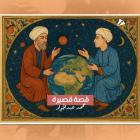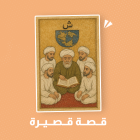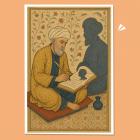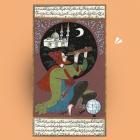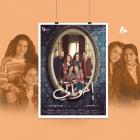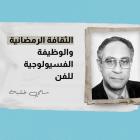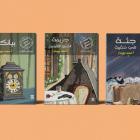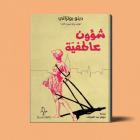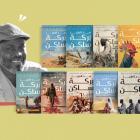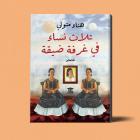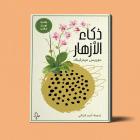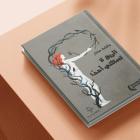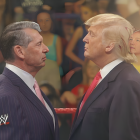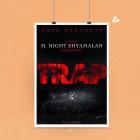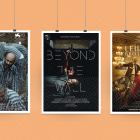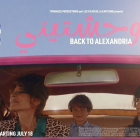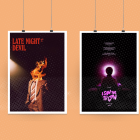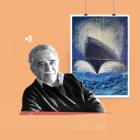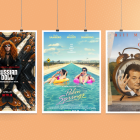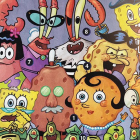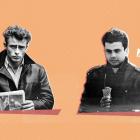فن
هحكل شفسلك — قصة قصيرة
أربعون عامًا من النحت في المعنى... وجملة واحدة أنهت كل شيء!
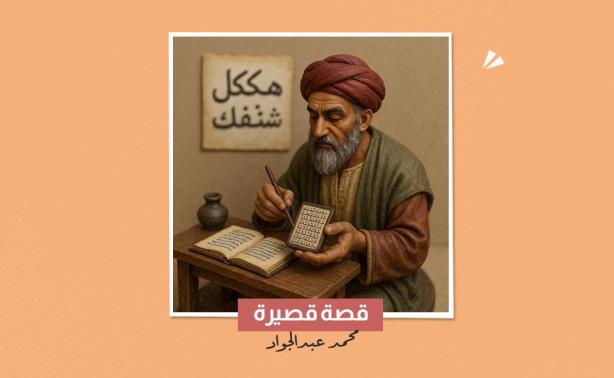 صورة تعبيرية باستخدام ChatGPT
صورة تعبيرية باستخدام ChatGPT
لا يُعرَف أحمد بن برهان أو يُعرَّف سوى بحياته في زمنٍ مهووس، كتب فيه آخر، وهو الجاحظ، الذي نعرف جميعًا أنه مات بطريقة مباركة ودرامية: غرق في موجة من بحر مكتبته التي انتفضت فجأة، وكان الجاحظ يَنظر أن الجنة بالنسبة للكتاب ستكون مكتبة كبيرة، مثلما تصوّر المعري في «رسالة الغفران» أن الجنة كلها شعراء، أو العالم الآخر في العموم. أحمد بن برهان، والذي يُكتب عنه هكذا بالضبط حين يُعرَّف؛ عالم نحوي إسلامي ومترجم شهير من اليونانية، له عدة إسهامات في مجال اللغة، احترقت جميعها مع ضياع مكتبة بغداد الكبرى وقت الغزو المغولي، واشتهر عنه بعض الابتكارات الجديدة الخاصة بطريقة قراءة الكتب.
كتب هذا التعريف البروفيسور الهولندي «س. شيورد»، نقلًا عن أستاذ جامعي مصري محترم ومخضرم من الرعيل الأول، اسمه الدكتور عبد العليم طعيمة، كان قد أعدّ موسوعة خاصة أسماها «أعلام سوداء»، يتحدث فيها عن الأعلام غير المعروفة من علماء العرب، ورمز لها باللون الأسود لأنه لون يطمس الحقيقة.
المهم؛ كلمة «ابتكارات بن برهان الخاصة بالقراءة» هذه؛ كان أساسها أنه فكّر بأن حجم الكتب وطبيعتها يجعلانها رهينة الفناء بسهولة، وتتعرض للتلف. وكانت تلك ملاحظته عندما كان يسافر من بغداد إلى البصرة مثلًا أو إلى دمشق، لأمر عمل أو درس، حيث يجد الكتب، بعد الرحلة، قد تلف نصفها بسبب الرطوبة والرمال والحرارة وغيرها من المهلكات. وكان ذلك يحدث لكل القوافل تقريبًا، وزاد منه التعامل غير المكترث لأرباب هذه القوافل، حيث كانوا يلقون بالأكوام على الأرض بلا قلب — يشبه، مع قليل من الخيال، مشهد إلقاء حقائب السفر على أرض المطار الزلقة بيوم مطير في مدينة باردة.
ولذلك، فقد بحث في البداية عن طريقة أخرى لنقل الكتب بدلًا من هذه الطريقة السوداء، ولكنه وجد أثناء بحثه هذا أن خامة الكتاب نفسه لا تساعد على الحفاظ عليه، فتكوينه الأساسي من الورق وجلد الحيوان جعله أكثر هشاشة من تحمّل أي وسيلة نقل.
انشغل بهذه المعضلة بطريقة شبه مهووسة، ودفعه هذا إلى دراسة طرق الشعوب والحضارات الأخرى في الحفاظ على الكتابة، فانبهر مثلًا بحضارة الفراعنة التي تحتفظ بالكتابة فوق الحجر حتى ملايين السنين، لكنه حلّ غير عملي، لا يرقى سوى أن يكون زينة للناظرين من أجيال لاحقة، ونقل جدار أو حجر أكثر صعوبة، كما يتعرض لما تتعرض له أي مادة للتلف والطمس.
قرأ عن طرق اليونانيين في الحفاظ على ورق البردي، كما يفعل الفراعنة أيضًا، وهي الطريقة نفسها التي انتقلت إلى الحضارة العربية الإسلامية، وعن الكتابة السومرية فوق أحجار طينية حمراء قيل إنها لا تتلف ولو احترقت، وعن كتابات الصينيين فوق أطباق خزفية يسهل حملها. لكنه شعر بأن نقل كتب مكتبة واحدة في بغداد، أو مكتبته مثلًا، لتكون معه حيثما كان، أكثر صعوبة من التنفيذ بسبب استعصاء المادة هذا.
وكان ذلك في إحدى رحلاته التي تقطع الصحاري بين العراق والشام، عندما تشتدّ حدة الشمس، ويصاب الوجود بالفتور والكدر، ويظهر الماء على هيئة حلم بعيد؛ أعجبه انعكاس شعاع الشمس فوق الرمل، والذي كان من مكونات اختراع المرآة، وخطرت في باله فكرة تتهادى في الزمن الراكد، ففكر — وهو يتأمل لمعان الرمل في كفه وهي تضيء بألق الشمس — أن كتاب أحلامه سيكون مطبوعًا فوق الكف، يُقرأ في أي مكان، ويمكن تقليبه بالإصبع.
انشغل طوال رحلته بالفكرة، درسها من كل جوانبها، وبدأ يرسم بالحبر صورة «الكتاب الكف»، بما يشبه نسخ الإنجيل الصغيرة التي يطبعها الرهبان السريان في الشام وفلسطين، لتكون كلمة الرب معهم في كل مكان بموقع القلب، ولكن تلتصق باليد، لا تغادره. هذه المعجزة التي لم يجد لها حلًّا شغلته قرابة عشرين عامًا، قضاها في محاولة العثور على إجابة الاحتفاظ بالكتاب في كفه. كتاب صغير جدًا، يضم الكتب المعروفة، ويستطيع الاطلاع عليه بسهولة.
كان يقترب من الفكرة أحيانًا في هذه الأعوام، ثم يبتعد عنها مع الانحرافات المزاجية، والجوائح، وتغيّر دفة الحكم، حتى لجأ إلى ابتكار لغة خاصة، مشتقة من العربية مع بعض نفحات الفارسية، يمكن بها اختزال ملخصات الكتب الهامة بجملة أو عبارتين أو بعض أبيات الشعر. اهتدى في ذلك بالاختزال القرآني الشهير في شرح فكرة أن الأرض مدوّرة، وأن كل شيء يدور حول نفسه بنظام يشرف عليه الله، الذي يحوي الدائرة ولا تحتويه، وهي: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾. حيث إن «كل» هي نهاية «كل فلك» معكوسة، لتصير الكلمة رسالة دائرية لا تنتهي، وممتدة بامتداد الله، الذي لا نهاية له ولا بداية.
فقرّر تلخيص بعض كتب الفلسفة والطب والتاريخ وقتها، وهو ما لزم منه عشرين عامًا أخرى، ليكمل أربعين عامًا كاملة، يعتبرها بعض علماء التصوف الزمن الكافي ليكون الرجل رجلًا، وتنضج التجارب، ويكون نبيًّا. وخرج بعد هذا بنسخ صغيرة جدًا، بحجم الكف، تشبه كتب الرهبان، بكل صفحة فيها عبارات منظومة بعناية كلّت لها عينه اليسرى، أشهرها العبارة التي اتخذت بعدها كمثل في المحاكم القانونية: «العدل أساس المُلك»، ولكن الكثير من الجمل، غير هذه الجمل العادية التي ابتكرها سريعًا، تخص عبارات غير مفهومة، وتحتاج إلى عقل خاص وتحليل للفهم.
اشتهر أمر اختراعه الخاص هذا، بكتيب واحد متعدد الصفحات، كتبت فيه جمله التي تختصر علوم قرون مؤلفة بالعربية أو مترجمة من مصدر آخر، وصار بعض العلماء الكبار في زمنه يزورونه للاطلاع على كتابه. ورغم أنه كان عالمًا ربانيًا، وله فتوحات خاصة في مجال الفقه، لم يتخلَّ عن رغبته في الاحتفاظ بسرية شيفراته تلك، والاكتفاء بالابتسام بغموض وهو يقول إن جملةً مثلًا تلخص «كتاب الحيوان» للجاحظ، أو تلخص كتابًا من كتب جالينوس.
احتفظ بغروره العلمي المفهوم هذا، وكان مزمعًا على أن يكتب كتابًا جديدًا، يضم فيه كل كتاب يصدر حديثًا بزمنه، ولم يسلم من استضافة الخليفة المعتمد بالله، الذي كان يحاول الانشغال عن صراعات القادة الأتراك لجيشه حينها بمجالس العلماء والمؤانسة الشرعية. فقرأ له أحمد بن برهان بعض العبارات غير المفهومة، حاول الخليفة المعتمد بالله دفعه إلى تفسيرها، فلم يفسر سوى عبارة واحدة تخص طبيعة الضوء وكيفية انتقاله من مكان إلى مكان، فتعجب الخليفة المعتمد من بهاء الاختراع، وقرّر أن يوقف مدرسة خاصة لأحمد بن برهان، لإنشاء مكتبة كاملة من كتب بحجم الكف تحوي علوم كل شيء بجمل واضحة وجريئة.
كان الأمر يسير بصورة حسنة، رغم صلف بن برهان في التعامل مع نقل المعلومة للطلبة، وحذره الطبيعي من كل من يريد فكّ الشيفرات بدون مجهود، ولم يكن قد انتهى من مقدمات كتاب جديد، خصصه للأحداث التاريخية التي جرت في دولة بني العباس منذ نشأتها وحتى المعتمد بالله، كما طلب منه الأخير، مع فهرس آخر مختوم بخاتم السلطان لا يُفتح سوى بإذن خاص حتى يُفسر أحاجي التاريخ المكتوبة مشفّرة، عندما أصابه نسيان خفيف بسبب الشيخوخة وإفناء العقل بالدراسة وتلخيص ألفي صفحة في جملة مصفّاة.
فبدأ ينسى كل ما كان يكتبه، والمشكلة الأساسية أنه كان عنيدًا بالقدر الكافي ليحاول تذكّر كل ما كتبه، والتخلي عن غروره، لأنه عدّ ما جرى عقابًا إلهيًا عادلًا، بسبب حبسه العلم، ولم يتهاون، بخضم ذلك، في تعزية نفسه بأن ذلك كان بسبب تقديره لما قام به خلال ليالٍ بلا قمر، وبرودة ودفء، وشك وحزن، ونَظم للعبارات.
عكف على ترجمة العبارات وفك شفراتها مرة أخرى، ومكث في ذلك عشرة أعوام إضافية، بمساعدة طلبة المدرسة التي أسماها «المدرسة البرهانية»، وعندما نجح في استعادة كل ذلك، ووصل إلى العبارة الأخيرة في الكتاب، وهي العبارة رقم سبعين ألفًا وخمس وأربعين، وكانت كالتالي: «هحكل شفسلك»، توقف عندها ليقوم بعمل احتفال خاص، وزع فيه قربانًا برعاية الخليفة، الذي استمتع بقراءة بعض الجمل المفسَّرة حديثًا، ثم نسيها بحكم الانشغالات.
وبعد نهاية الاحتفالات في العيد الكبير وقتها، عكف على تفسير آخر عباراته لما قبل النسيان، وكانت مستعصية عليه وعلى أقرب طلبته إلى قلبه، الحسن الفرزدق، فأخذت عامًا آخر حتى كشف سرّها بسهولة، عن طريق أول حرف فيها، حيث كان يمسك الحرف ويضعه في احتمالات كلمات لا متناهية حتى يصل إلى المعنى، كما كان يفعل مع باقي العبارات، فوجد العبارة واضحة جدًا، جلية مثل قمر يوم ميلاده منذ ثمانين عامًا:
«هذا حاصل كل شيء، فلا سبب لحياتك».
قيل إنه مات بعدها من أثر قوة العبارة وحدها، ويمكن أن يكون قد مات بسبب الخوف من النبوءة القوية في العبارة أو الثقة التي كُتبت بها. ولكن السبب الحقيقي، الذي لا يعرفه غيره، أنه أدرك بشكل واضح أنه لم يكتب هذه العبارة أبدًا، وأنها كانت العبارة «بعد الأخيرة» في كتابه المعجز، والتي كُتبت بيد لا يعرفها، وهو ما لم يستطع احتماله، لأنها تفتح الباب على احتمالات شتى.
لم يبقَ من الكتاب بعدها سوى بعض العبارات التي استطاع الحسن الفرزدق استخلاصها من النسيان، والجو المحترق بالفتن التركية في الجيش العباسي، وهي العبارات التي وصلت إلينا كاملة، مثل: «العدل أساس المُلك» المشار إليها في السابق، وغيرها من العبارات التي تنتقص من حق أحمد بن برهان العظيم في اختصار كل علوم العالم بما يسهل قراءتها في أي مكان، أو ما سيكون بعدها بقرون أساس قوة اختراع جهاز التابلت.